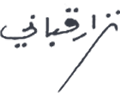بقلم : رضوان السح
نزار قباني، المتربع على مجد شعبي لا نظير له في العالم العربي، لا يستهويه ارتداء زي الناقد الأدبي؛ فهو إذا ما سـئل في الشعر راح يجيب بدلال الطفل الواثق من محبة الآخرين له، لأنهم يستظرفون كل ما يصدر عن عفويته، حتى حماقات الطفولة جميلة، وربما كانت صفة الحماقة في غير مكانها حين تطلق على البراءة.
هكذا هو نزار قباني في كتاباته وأحاديثه حول الشعر.
في كتابه «ما هو الشعر» لن نرى من النقد الأدبي إلا قصيدة نزارية تتحدث عن الشعر، فالأحكام النقدية ينبغي استنباطها بعملية تأويلية.
لنستمع ما هو الشعر عند نزار قباني:
«ليس للشعر صورة فوتوغرافية معروفة وليس له عمر معروف، أو أصل.. ولا أحد يعرف من أين أتى، وبأي جواز سفر يتنقل.. المعمرون يقولون: إنه هبط من مغارة في رأس الجبل، واشترى خبزاً، وقهوة، وكتباً، وجرائد من المدينة.. ثم اختفى..» ويتابع قباني: ماذا قال سكان الشواطئ عنه وماذا قال أطفال المدينة ونساء المدينة، ومعلمو المدارس؟!.. وتأويل كل ذلك أنه ليس ثمة تعريف للشعر: «ليس هناك نظرية للشعر.. كل شاعر يحمل نظريته معه» هذه العبارة الأخيرة ربما كانت الأقرب الى اللغة النقدية أو العقلية أو التجريدية الذهنية.
إن إدراك نزار قباني أن فوزه لم يكن إلا بامتلاكه الأدوات الإبداعية يجعله متهيباً من استعمال أدوات النقد، فالشعر غير مطالب بالنظرية والتنظير، وإذاً فلماذا المغامرة!: «الشعراء الذين حاولوا أن ينظروا في الشعر خسروا شعرهم، ولم يربحوا النظرية، باعوا الشمس.. واشتغلوا على تركيب لمبة كهربائية من خمسين شمعة..».
هذه هي لغة الحدس والعرفان أمام لغة المنطق والعقل.. فالعقل محدود وقاصر أمام الأوقيانوس العظيم للحدس والخيال.
لا يريد نزار قباني من الشاعر أن يدخل مشرحة النقد، فعمله هو أن يفتن بالجمال، لا أن يحلل تركيبه:
«باعوا فم الحبيبة الجميلة.. واهتموا بعدد أسنانها» ولكن ماذا بشأن الناقد غير المعني بالإبداع؟
لا يجيب نزار، إنه معني بما يخصه، وهو شاعر، ولذا يجيب حول ما يعني الشعراء.
ولذا فإن فكرة أرجحية الحدس على العقل تستغرق صفحات في كتاب «ما هو الشعر» إن لم نقل إنها تمثل عموده الفقري: «ما أسهل كتابة الشعر.. وما أصعب الكلام عنه.. الشعر هو الرقص.. والكلام عنه، هو علم مراقبة الخطوات... وأنا بصراحة أحب أن أرقص.. ولا يعنيني التفكير بحركة قدمي، لأن مجرد التفكير بما أفعل يفقدني توازني.. إنني أرقص.. ولا أعرف كيف. وأكتب الشعر كما لا تدري السمكة كيف تسبح.. والأرنب كيف يقفز.. والنهد كيف يخالف الجاذبية الأرضية».
ومنحى «اللاأدرية» هو منحى حدسي أيضاً، لا يتورط في القوالب الذهنية الجاهزة، ولذا يلجأ إليه نزار: «ما هو الشعر؟ لا أعرف.. لا أعرف.. لا أعرف..».
إذا كان هذا هو جوابه فلماذا يضع كتاباً يقع في مئتين وست صفحات وإن كان من القطع الصغير بعنوان «ما هو الشعر؟».
إن نزار قباني كما أسفلنا يريد أن يكتب قصيدة موضوعها هو الشعر، وهذا ليس أمراً طارئاً وجديداً في الموضوعات الشعرية؛ فالشعر قد شغل بنفسه منذ القدم كموضوع وفي شعرنا العربي نرى جذور هذا الموضوع ضاربة في الشعر الجاهلي، كما نرى أغصانه ممتدة الى أحدث قصائدنا.
ونزار قباني في قصيدته هذه يطرح أفكاراً في نظرية الشعر تلبس لغة الشعر وتخييلاته، إلا أنها في المحصلة أفكار يمكن أن تستنبط لتشكل رأياً لنزار قباني في نظرية الشعر نلخصها على النحو الآتي:
1 الشعر ثورة كونية ميتافيزيقية.
2 القصيدة الجيدة هي قصيدة تتصادم مع عصرها.
3 الشعر ثورة في اللغة.
4 شروط الشعر هي الحرية المطلقة «الطفولة الشيطنة..».
فلا يقع في «العقلنة» والأيديولوجيات.
5 الشعر من أعمال المعارضة لا الموالاة، لأنه يقوم على الرفض لا القبول.
6 الشعر رسالة، ولذا ينبغي أن تصل الى المرسل إليه.
ولأن نزار قباني مطمئن الى جمهوره العربي العريض يتوسع في حديثه حول البند الأخير: «لماذا يعيد موزع البريد قصائد أكثر شعرائنا إليهم؟ لأنهم نسوا عنوان الشعب، أو تناسوه.. أو لأنهم نفوا أنفسهم خارج أسوار اللغة».
ولنزار قباني رأي مهم هنا في مسألة غموض الشعر العربي الحديث، الذي تسبب في القطيعة مع القارئ؛ إذ يقول: «كما أنه ليس ثمة أوتوسترادات تفتح لمرور شخص واحد، فليس هناك لغة تنشأ ليستعملها شخص واحد.. ولكن الشعر الحديث أو أكثره لا يعرف بمنطق نشوء اللغات.. ولا بمنطق شق الأوتوسترادات.. وأنا أتهم عدداً كبيراً من شعراء الحداثة، وهم في غالبيتهم يساريون واشتراكيون وتقدميون، بممارسة إقطاع شعري على الشعب العربي، لا يختلف عن الإقطاع الثقافي والفكري الذي كان يمارسه النبلاء في العصور الوسطى».
وهؤلاء الشعراء هم الذين يعنيهم بقوله: «وهناك أخيراً شعراء يضاجعون أنفسهم.. وليست لديهم الشهوة للاقتراب من الجنس الآخر (الجمهور) أما أنا فشاعر طبيعي الميول، قرر أن يتزوج الوطن العربي ويستولده ألوف القصائد والأطفال».
ونختم حديثنا حول هذا الكتاب الذي يستمد قيمته النقدية من أنه يمثل رأي شاعر من أهم الشعراء العرب المعاصرين.. نختم بقضية مهمة تتعلق برأي مؤلفه في القصيدة النثرية: «قصيدة النثر هي مصطلح جديد لمفهوم قديم، إنها موجودة منذ أن أدرك الإنسان أن العبارة الوحيدة يمكن أن تقال بعشرات الصيغ، ولها عشرات الاحتمالات.
احتمالات الكلام لا نهائية، ومن هذه الاحتمالات (قصيدة النثر) التي نجد لها أصولاً في الكتب المقدسة كما في سورة مريم، وسورة الرحمن، وفي قصار السور القرآنية، كذلك نجدها في نشيد الإنشاد وفي المزامير.
إنني شخصياً لا أجد قصيدة النثر غريبة عن ميراثها ولا عن ديناميكية اللغة العربية التي تتفجر بملايين الاحتمالات.. وفي هذا العصر المتطرف في ليبراليته وغضبه، وتطرفه وملله، وتحولاته، تبدو قصيدة النثر وكأنها الجواب المناسب لما يريد العصر أن يقوله..
ومع كل التحولات والخضات والزلازل التي يتعرض لها الفكر العربي في هذه الحقبة، أتوقع أن تكون قصيدة النثر هي قصيدة المستقبل.. لأنها الأشجع والأكثر حرية».
وحين يواجهه سؤال: «ألا تخشى من إعطاء هذه الفتوى على مستقبل الشعر العربي»؟ يقول: «مستقبل الشعر العربي يكون بدخول المغامرة لا بالجلوس في مقهى تنابلة السلطان».
«كل عمل عظيم كان في الأساس مغامرة» ولم ينس شاعرنا الكبير المأزق الذي وقعت فيه الحداثة، وكانت تريد تخليص القصيدة العربية منه، وهو مأزق التناظر والتكرار؛ ولذلك تشابهت القصائد الحديثة «أسلوباً ولغة وأداء كما يتشابه عشرون توءماً نزلوا كلهم من بطن واحد.. فإذا قرأت لواحد منهم أغنتك قراءتك له عن قراءة الباقين، فكأنما الشعر الحديث كله هو قصيدة واحدة يوقعها مئة شاعر».
وفي الكتاب آراء أخرى في شجون الشعر، إلا أنها مكرورة بشكل أو بآخر؛ فقد أفاد شاعرنا جيداً من مسألة أن تقال العبارة الواحدة بعشرات الصيغ!.